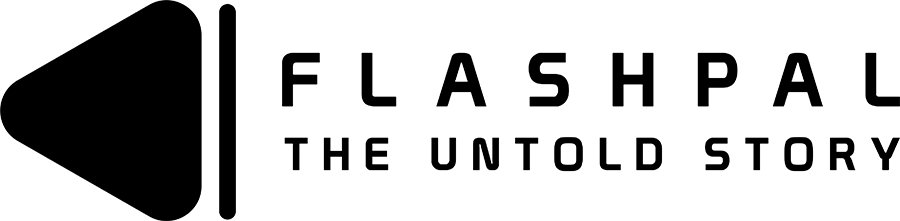رحل البابا فرانسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية، بعد حياة حافلة بالتغيير والتجديد داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية. توفي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن قضى أيامه الأخيرة مشاركًا قدر استطاعته في احتفالات عيد الفصح، حيث ظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس موجهًا بركته الأخيرة للمؤمنين. هذه اللحظة الرمزية لخصت روح البابا الذي اختار أن يبقى قريبًا من الناس حتى في لحظاته الأخيرة، مجسدًا نموذجًا مغايرًا للقيادة البابوية التقليدية.
منذ انتخابه في 2013، مثل البابا فرانسيس قطيعة مع الماضي، ليس فقط كونه أول يسوعي يقود الكنيسة، بل أيضًا كرجل أتى من خارج الدوائر التقليدية للفاتيكان. ركز على الفقراء، والمهاجرين، وحماية البيئة، وسعى لإعادة الكنيسة إلى جوهر رسالتها الروحية، مبتعدًا عن المظاهر والامتيازات التي لطالما ارتبطت بالمنصب البابوي. رفض الإقامة في القصر الرسولي، مفضلًا العيش في بيت الضيافة، في رسالة واضحة عن بساطة السلطة وخدمتها.
غير أن إصلاحاته واجهت مقاومة شرسة من تيارات محافظة داخل الكنيسة، التي رأت في تحركاته تهديدًا للثوابت العقائدية والمؤسسية. كذلك، ورث أزمة عميقة من سلفه بنديكتوس السادس عشر، تمثلت في فضائح الاعتداءات الجنسية وأزمات إدارة الفاتيكان، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالبنك الفاتيكاني. حاول فرانسيس تقويم هذه الأعطاب لكن معوقات البيروقراطية والفصائل المتنافسة داخل الكنيسة حدّت من نطاق نجاحه.
رغم هذه التحديات، سيبقى البابا فرانسيس في الذاكرة رمزًا لمحاولة إعادة تعريف الكنيسة في القرن الحادي والعشرين. لقد مدّ الجسور مع الأديان والثقافات الأخرى، وفتح الباب لنقاشات لم تكن مطروحة سابقًا داخل المؤسسة الكاثوليكية. برحيله، تفتح مرحلة جديدة أمام الكنيسة، تختبر مدى عمق التأثير الذي تركه، وتعيد طرح سؤال: هل تستطيع المؤسسة الكنسية أن تستمر بروح فرانسيس، أم أن رحيله سيؤدي إلى انتكاسة تعيد عقارب الزمن إلى الوراء؟